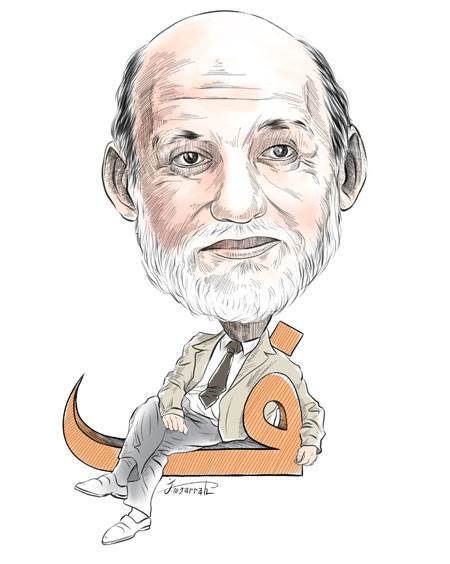 عام 1999 التقيته آخر مرة. حدث ذلك في الدوحة. كان يومها في
الخامسة والسبعين من عمره وظهر كما لو أنه ينزلق إلى النسيان. قال لي من غير أن
يكون مكترثا “لقد نسيت كيف يمكن أن يكون المرء رساما” كانت عيناه تلمعان وكان
مستسلما لقدره حين أضاف “أنا أصلي باستمرار، من أجل أن لا أنسى كلمات الصلاة”،
يومها أدركت أن شاكر حسن آل سعيد قد ختم رسالته في الفن.
عام 1999 التقيته آخر مرة. حدث ذلك في الدوحة. كان يومها في
الخامسة والسبعين من عمره وظهر كما لو أنه ينزلق إلى النسيان. قال لي من غير أن
يكون مكترثا “لقد نسيت كيف يمكن أن يكون المرء رساما” كانت عيناه تلمعان وكان
مستسلما لقدره حين أضاف “أنا أصلي باستمرار، من أجل أن لا أنسى كلمات الصلاة”،
يومها أدركت أن شاكر حسن آل سعيد قد ختم رسالته في الفن.
الرسم بعد
الموت
لم
يعد لديه ما يرسمه، كان محرجا أمامنا لأن البعض منا كان ينتظر أن يراه وهو يرسم.
لذلك صار يلهي نفسه ويسلينا برسم نقاط بأحجام مختلفة على الورق، نقاط بالحبر، على
طريقة فازرلي الذي أحب فنه يوما ما وكان يعتبره أقرب الرسامين المعاصرين إلى
الرؤية للفن.الإسلامية وهو ما يعكس ولع آل سعيد
بالزخرفة، بالرغم من أنه كان يتحاشى الزخرفة، لأنها لم تكن تشبع ميله إلى تأمل
الأثر الزائل.
لم
يكن الآخرون الذين أحاطوا به بمحبة يشعرون بالأسى الذي كان شيخ الحروفيين العرب
يعالجه عن طريق النقطة، وهو الذي كان يقول بلغته الصوفية “أنا النقطة فوق فاء
الحرف”. وكانت تلك الجملة الغامضة عنوانا لأحد كتبه.
“ربما رسمت بعد الموت” قال لي قبل
عقدين من لقائنا الأخير. فهل كان يفكر بتلك النقطة التي سيضيع فيها كل أثر يُذكّر
بماضيه؟
الثناء الجمالي على
المخلوقات
عام
1955 ذهب إلى باريس لدراسة الفن، وكان يومها فنانا مكرسا. فبعد دراسته العلوم
الاجتماعية في دار المعلمين وقبل أن ينهي دراسته المسائية للفن في معهد الفنون
الجميلة ببغداد كان آل سعيد قد احتل مكانة بارزة في جماعة بغداد للفن الحديث
(1951). يمكننا أن نصفه بأنه كان منظر تلك الجماعة فهو كاتب بيانها الأول. وهو أول
بيان تصدره جماعة فنية في التاريخ الفني العراقي المعاصر. كما أنه كان قد أقام أول
معرض شخصي لرسومه قبل سنة من سفره.
غير أن باريس لعبت دورا غريبا في
حياته. لقد تعرض الشاب المتحمس للفكر الوجودي إلى صدمة، لم يفصح عن مضمونها في أيّ
من مقالاته أو كتبه وكان يتفادى الحديث عنها. غير أن من نتائج تلك الصدمة أنه تحول
من الوجودية إلى الإيمان، بل إلى الفكر الصوفي. وهكذا يكون آل سعيد قد ذهب إلى
باريس وجوديا فعاد منها متصوفا. ذهب إليها رساما تشخيصيا ولكنه غادرها إلى بغداد
رساما تجريديا. كان ذلك التحول هو واحد من أهم تحولاته الفكرية والأسلوبية، وهو ما
مهد الطريق أمامه ليكون رائد بحث جمالي جديد في الفن العربي.
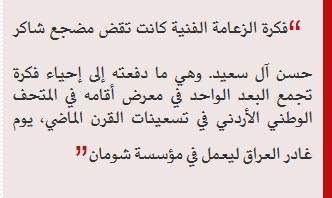 حين أصدر آل سعيد بيانه التأملي الشهير عام 1966 كان قد شق
طريقه الخاص في الفن، رساما تأمليا، يصنع عن طريق الفن حياة مجاورة، هي بالنسبة
إليه محاولة ثناء على الخلق الإلهي المتجسد ففي الإنسان كما في الطبيعة من
حوله.
حين أصدر آل سعيد بيانه التأملي الشهير عام 1966 كان قد شق
طريقه الخاص في الفن، رساما تأمليا، يصنع عن طريق الفن حياة مجاورة، هي بالنسبة
إليه محاولة ثناء على الخلق الإلهي المتجسد ففي الإنسان كما في الطبيعة من
حوله.
لم تكن شخصية آل سعيد تنطوي على أيّ
من مقومات الزعامة، فهي شخصية قلقة، مرتبكة، حائرة، مترددة وميالة إلى الشك في
البداهات. كان يليق به أن يكون الشخص الثاني، وهو ما كانه يوم كان جواد سليم
(الرسام العراقي الرائد ومؤسس جماعة بغداد للفن الحديث والمتوفي عام 1961) حيّا.
غير أن الرجل كان يدرك أن كشوفاته في الفكر الجمالي وفتوحاته الأسلوبية والتقنية
كانتا تؤهلانه لكي يكون زعيما لجماعة فنية. بهذا الإحساس أنشأ آل سعيد تجمع البعد
الواحد الذي أقام أول معرض له عام 1971. كان استلهام الحرف العربي جماليا محور تلك
المحاولة. غير أن فشل آل سعيد في أن يكون زعيما جعل عددا من أعضاء ذلك التجمع ينفضّ
من حوله، وهو ما ألحق ضعفا في المحاولة الثانية لإقامة معرض للتجمع، حيث لجأ آل
سعيد إلى إشراك عدد من الخطاطين الذين لا علاقة لهم بالرسم.
في حقيقته كان آل سعيد فردا خلاقا،
غير أن فكرة الزعامة الفنية التي هو ليس أهلا لها كانت تقض مضجعه. وهو ما دفعه إلى
إحياء فكرة تجمع البعد الواحد في معرض أقامه في المتحف الوطني الأردني في تسعينات
القرن الماضي، يوم غادر العراق ليعمل في مؤسسة شومان. كان ذلك المعرض بمثابة رثاء
لفكرة جميلة. لم يكن واحدا من المشاركين في ذلك المعرض ذا علاقة بفكر آل
سعيد.
كانت التجربة الحروفية واحدة من أهم
مراحل سيرته الفنية، غير أنها كانت تلاحقه باعتباره شيخ الحروفيين في العالم
العربي، بالرغم من أنه تاريخيا لم يكن الحروفي الأول. لقد سبقه العراقيان جميل حمدي
ومديحة عمر إلى ذلك. غير أن حروفية آل
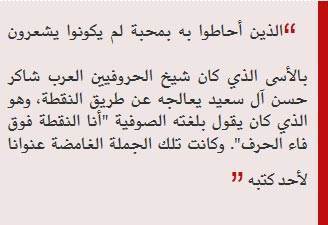 سعيد كانت شيئا مختلفا. لم تكن تزيينية كما هو الحال مع
حمودي ولم تكن توضيحية كما ظهرت في لوحات عمر. كان آل سعيد قد شقّ طريقه إلى الحرف
العربي بقوة الرسام الشقي الذي كان يرى في الكلمات المحذوفة والجمل الناقصة التي
يكتبها الناس على جدران المدينة بعدا جماليا يشير إلى نوع مكتمل من الحياة. لم تكن
فكرة استلهام الحرف العربي جماليا لدى آل سعيد محاولة للغزل بالحرف لذاته، بل ذهبت
تلك الفكرة إلى ما يمكن أن ينطوي عليه الحرف من فزع وخوف وارتباك تعبيري. كان آل
سعيد سيد الحروفيين لأنه لم ينسخ الحرف، بل اعتبره منجما لمشاعر، فجعت بالطرق
المسدودة من حولها. كان الحرف بالنسبة إليه فضاء تأويليا. غير أن شيخ الحروفيين لم
يعد حروفيا في العقدين الأخيرين من حياته. حين تسنت له فرصة كتابة مقالته (أنا
وتابيس) في منتصف ثمانينات القرن الماضي اعترف آل سعيد بأنه استلهم فكرة الجدار
العام من الرسام الإسباني. وكان ذلك الاعتراف نوعا من الفضيلة التي كان آل سعيد
يحرص على أن تكون ميزانا في الحياة الفنية. كانت علاقة آل سعيد بتابيس تنطوي على
التحدي أكثر من أن تكون علامة للاستسلام. كان آل سعيد يومها أكبر من أن يكون
متأثرا. غير أنه عثر في تجربة تابيس على ضالته التي كان يفكر فيها. سيقول “شكرا”
معلنة لتابيس لأنه أهداه تلك اللقية غير أنه لن يقلده. ولو أتيحت الفرصة لتابيس أن
يرى رسوم آل سعيد لخرّ أمامها ساجدا. سكون أمام تجربة رسام تعلّم منه ما لم يكن قد
سعى إليه.
سعيد كانت شيئا مختلفا. لم تكن تزيينية كما هو الحال مع
حمودي ولم تكن توضيحية كما ظهرت في لوحات عمر. كان آل سعيد قد شقّ طريقه إلى الحرف
العربي بقوة الرسام الشقي الذي كان يرى في الكلمات المحذوفة والجمل الناقصة التي
يكتبها الناس على جدران المدينة بعدا جماليا يشير إلى نوع مكتمل من الحياة. لم تكن
فكرة استلهام الحرف العربي جماليا لدى آل سعيد محاولة للغزل بالحرف لذاته، بل ذهبت
تلك الفكرة إلى ما يمكن أن ينطوي عليه الحرف من فزع وخوف وارتباك تعبيري. كان آل
سعيد سيد الحروفيين لأنه لم ينسخ الحرف، بل اعتبره منجما لمشاعر، فجعت بالطرق
المسدودة من حولها. كان الحرف بالنسبة إليه فضاء تأويليا. غير أن شيخ الحروفيين لم
يعد حروفيا في العقدين الأخيرين من حياته. حين تسنت له فرصة كتابة مقالته (أنا
وتابيس) في منتصف ثمانينات القرن الماضي اعترف آل سعيد بأنه استلهم فكرة الجدار
العام من الرسام الإسباني. وكان ذلك الاعتراف نوعا من الفضيلة التي كان آل سعيد
يحرص على أن تكون ميزانا في الحياة الفنية. كانت علاقة آل سعيد بتابيس تنطوي على
التحدي أكثر من أن تكون علامة للاستسلام. كان آل سعيد يومها أكبر من أن يكون
متأثرا. غير أنه عثر في تجربة تابيس على ضالته التي كان يفكر فيها. سيقول “شكرا”
معلنة لتابيس لأنه أهداه تلك اللقية غير أنه لن يقلده. ولو أتيحت الفرصة لتابيس أن
يرى رسوم آل سعيد لخرّ أمامها ساجدا. سكون أمام تجربة رسام تعلّم منه ما لم يكن قد
سعى إليه.
الرسام النخبوي
الذي يحلم بالشعب
لم
يكن آل سعيد نخبويا في فهمه للفن. غير أن الفن في طبيعته هو شيء نخبوي. فهل كان على
الرسام وهو يلتقط مواده من الحياة اليومية أن يقلق حين يرى أن الغموض يخيم على
العلاقة بين المشاهدين ولوحاته؟ كان مهما بالنسبة إليه أن لا يكون رساما بالمعنى
الشعبي. فهل كان سعيدا بغموضه؟ يوم رسم لوحته المزدوجة التي تُرى من جهتين كان
سعيدا بالتأكيد. كانت تلك المحاولة إنجازا شخصيا في تاريخ الرسم، من خلالها استطاع
آل سعيد أن يلغي ثبات اللوحة عل خلفية بعينها. في تلك اللوحة يمكنك النظر بطريقتين
مختلفتين. كانت اللوحة المزدوجة واحدة من وصفاته التي سيقف أمامها الرسامون
والمهتمون بالرسم ونقاده مندهشين. الرسام الذي توفي عام 2004 كان فاتحا، لا بكتبه
أو رسومه وحدها، بل وأيضا بنظريته في أن يكون الفن مستلهما من حياة الشعب. بمعنى أن
يكون الجمال سيدا في لعبة لن يمتنع الشعب عن المشاركة فيها.
من
العرب